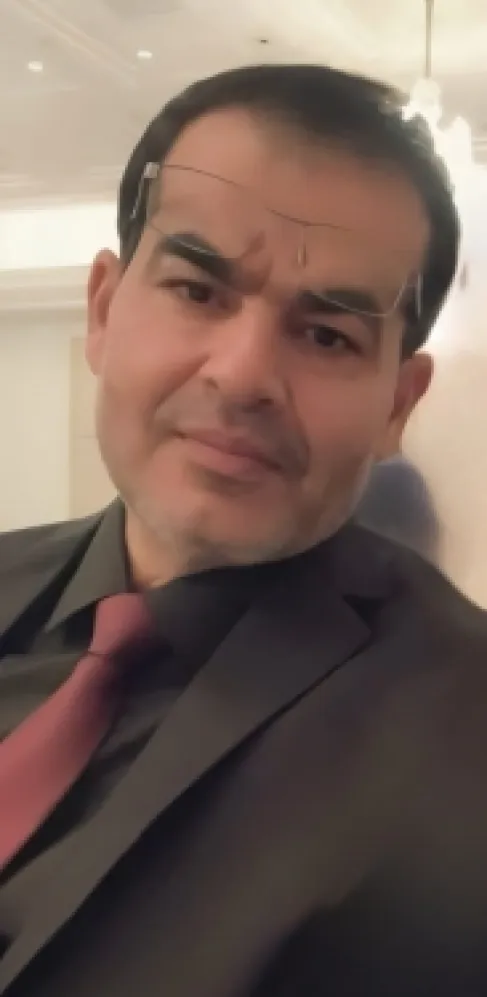تشهد أروقة القضاء الإداري في الأردن تنامياً ملحوظاً في وتيرة الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة. هذا الحراك القضائي، الذي ينتهي في حالات غير قليلة بالحكم ببطلان القرار الإداري، لا يمكن قراءته بوصفه مجرد نمو في الوعي الحقوقي للمواطن فحسب، بل هو بالدرجة الأولى انعكاس لأزمة كامنة في مطبخ صناعة القرار داخل الجهاز البيروقراطي. فلجوء المتضرر إلى المحكمة الإدارية هو شهادة حية على إخفاق الضبط الذاتي داخل المؤسسة، وإشارة إلى أن الشرعية الإجرائية باتت ثانوية أمام رغبات الإدارة.
تكمن الجدلية الأساسية في الإدارة العامة اليوم في المسافة الفاصلة بين الرغبة في الإنجاز وبين الامتثال للنص. وتكرار صدور أحكام ببطلان القرارات الإدارية يشير إلى خلل بنيوي في إدراك المسؤولين الحكوميين لطبيعة السلطة التقديرية؛ فهي ليست صكاً مفتوحاً لممارسة الإرادة الذاتية، بل هي مساحة محكومة بغايات القانون ومقاصد المشرع. فعندما يبطل القضاء قراراً بسبب عيب في الشكل أو انحراف في السلطة، فذلك يكشف عن مدى الاستسهال في تجاوز التنسيبات القانونية المتخصصة. وهذا الانفصال بين القيادة الإدارية والعمق القانوني للمؤسسة -إن وجد- يحوّل القرار من أداة للتنظيم إلى عبء قانوني ومالي، ويوحي بأن هناك من يعتقد أن الاجتهاد يمنحه الحق في القفز فوق الأنظمة والتعليمات بدعوى المصلحة العامة التي لا يستقيم تعريفها خارج إطار القانون.
إن جوهر الحكم ببطلان القرار الإداري ما هو إلا إعلان عن فشل المنظومة الرقابية الداخلية. فالمسؤول الذي يصدر قراراً يتضح لاحقاً مخالفته الصريحة للقانون، ويضع الدولة في حالة من عدم استقرار المراكز القانونية. وهنا تبرز مسألة المساءلة: هل يتم التعامل مع قرار الإبطال بوصفه خسارة قضائية عابرة، أم بوصفه مؤشر أداء يعكس ضعف الإلمام بالتشريعات؟. الواضح أن ازدياد هذه الحالات يوحي بأن القوانين والأنظمة باتت تُعامل لدى البعض كعقبات إجرائية يمكن الالتفاف عليها، وليس كإطار مرجعي يمنح القرار شرعيته. فغياب الثقافة القانونية الإدارية لدى الإدارة العليا يؤدي بالضرورة إلى قرارات مشوبة بعيوب جوهرية، مما يجعل القضاء الإداري هو خط الدفاع الأخير لتصويب مسار الإدارة الذي انحرف نتيجة نقص المعرفة أو فائض الثقة بالذات.
بعيداً عن الجانب القانوني الصرف، إن بطلان القرارات الإدارية يترتب عليه كلف تنموية وبيروقراطية باهظة. فإبطال قرار متعلق بتعيين، أو عطاء، أو عقوبة إدارية، يعني العودة إلى نقطة الصفر بعد ضياع وقت، وجهد، وموارد وطنية. فهذا النمط من الإدارة بالتراجع يزعزع الثقة العامة في كفاءة الدولة ومصداقيتها. وبدلاً من أن تكون الإدارة هي النموذج في تطبيق القانون، تضع نفسها مراراً في موقف المدافع الخاسر أمام منصة القضاء. وهو مشهد يفرض تساؤلاً حول جدوى منظومة تقييم القيادات؛ فإذا كان المعيار هو الجهد، فإن الحقيقة الإدارية تقول إن الأداء الحقيقي هو الذي يصمد أمام الفحص القضائي ولا ينهار عند أول اختبار للمشروعية.
ختاماً، يمثل تنامي الطعون الإدارية في الأردن جرس إنذار يستوجب إعادة الاعتبار لمبدأ المشروعية. فقوة المسؤول لا تستمد من قدرته على تجاوز النصوص بدعوى الاجتهاد، بل من قدرته على تطويع أدوات الإدارة للمصلحة العامة، ويبقى السؤال مفتوحاً أمام صانع السياسات: إلى أي مدى يمكننا الاستمرار في تحمل كلفة القرارات التي تولد مشوهة قانونياً، قبل أن ندرك أن فجوة الالتزام بالأنظمة هي العائق الأول أمام أي إصلاح إداري حقيقي؟