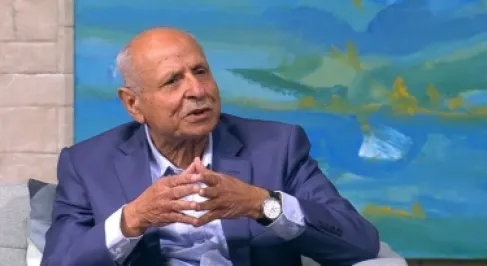الضفة التي يعرفها الجغرافيون ليست هي الضفة التي تصنع التاريخ. تلك ضفة ترسمها الاتفاقيات والحروب، ومنها ضفة نهر الأردن التي تحولت إلى جرح مفتوح في وعي الأمة. أما الضفة الأخرى، التي تصنع التاريخ، فهي ما يرسمه البشر حين يقفون على حافة الانهيار ليحولوا السقوط إلى وقوف.
حين ولدت الملكة رانيا في الكويت لأسرة من طولكرم، كانت الضفة بالنسبة لها أكثر من عنوان في الذاكرة العائلية، كانت تلك الأرض التي يظل فيها الفلسطينيون متمسكين بها رغم الاحتلال، كمن يتمسك برئته وهو يغرق. هي لم تختر مولدا، لكنها اختارت معنى. والذين يخلطون بين الجغرافيا والقدر لا يفهمون أن الإنسان يصنع ضفته حيث يرسو، لا حيث ولد!
في السنوات التي أعقبت العواصف، وجدت هذه المرأة نفسها في مرمى نقد لم يكن عنها، بل عن فكرة الانتماء. سامحوني، لكن من يحاكم امرأة بأصولها ومنبتها لا يفهم أن الإنسان ليس شجرة، بل نهر.
الشجرة تبقى حيث زرعت، لكن النهر يصنع طريقه، يروي أراضٍ لم تكن تتوقع الماء. هي اختارت أن تصنع طريقها. هي ممن يحملون منبعهم في قلوبهم، يجري بهم إلى العالم فيصنعون الحياة حيث يمرون.
البروتوكول الملكي يمنحها موقعاً، لكن التأثير الحقيقي لا يُمنح بتاج. هي اختارت أن يكون حضورها في الميدان، في مبادرات التعليم، في الدفاع عن الأطفال، في حمل قضايا اللاجئين إلى منابر لا تسمع عادةً إلا أصوات الرؤساء. من لا منصب تنفيذي لها استطاعت أن تنفذ إلى وعي العالم أكثر من كثيرين ممن يملكون الجيوش. ليس لأنها ملكة، بل لأنها فهمت أن الضفة الحقيقية لا تُصنع بالقرارات، بل بالحضور الذي يتحول إلى معنى. هي في نيودلهي تخاطب قادة العالم، وهي في قرية نائية تسمع همس أم تخشى على مستقبل أطفالها. في كلا المشهدين، تصنع الشيء نفسه: صورة وطن لا يُعرف بمساحته، بل باتساع كرامته. في لقمة الخبز التي تصل، والكرامة التي لا تُهان، والحق الذي لا يُباع.
ثم جاءت اللحظة التي وقفت فيها في نيودلهي، تتحدث عن التواضع كفضيلة قيادة: "ما الذي نتسابق نحوه؟". في تلك الكلمات، كانت تعيد رسم الضفة من جديد. هذه المرة، الضفة ليست جغرافية، بل حدود أخلاقية للقوة. هي الاعتراف بأن من يقف على الضفة العالية يرى أبعد، لكنه يرى أيضاً من يسقطون في الماء!
التواضع ليس وهناً، بل نتيجة حتمية لمن رأى ما تفعله السيول حين تظن نفسها أنهاراً. السيول تكتسح ثم تنحسر، ولا يبقى منها إلا الخراب. أما الأنهار فتبقى لأن لها ضفافاً. وضفة الكرامة التي ترسمها اليوم تمتد من نهر الأردن إلى العالم، لا تعترف بالحدود التي ترسمها الحروب، بل بالحدود التي ترسمها القلوب.
المفارقة أن الذين انتقدوها بالأمس بسبب ضفة هناك، هم اليوم أمام ضفة جديدة لا يستطيعون نقدها! لأنها ليست ضفة انتماء، بل ضفة إنسانية. حين تعيد رسم الخريطة، لا يعود لمن كان ضائعاً في الخريطة القديمة ما يقوله. الخريطة القديمة كانت ترى في الضفة الغربية بقعة متنازع عليها، أما الخريطة الجديدة فترى فيها منبعاً لإنسانية تتحدى الاحتلال. أصلها هناك، لكن رسالتها للعالم كله. هذا هو الفرق بين من يحمل جرحاً ومن يحوله إلى منهج!
الأردن نفسه قام على ضفتين لنهر واحد. وهي التي أتت من الضفة الأخرى، لم تأت لتقسم، بل لتوحد. في زمن التقطّع، من يبني الجسور هو الملك الفعلي. والملكة، التي تحمل نبض تلك الضفة، تنقل معاناة أهلها إلى العالم بلغة لا تعرفها الدبلوماسية: لغة الأمومة، لغة الكرامة، لغة الإنسانية التي لا تقبل المساومة. هي لا تتحدث باسمهم، لكنهم يتحدثون من خلالها!
وفي عالم يتسابق فيه الجميع نحو المجهول، تقف هي لتذكرهم بأن التقدم ليس سرعة الوصول، بل جودة الوصول! وأن من وصل ومعه الآخرون أفضل ممن وصل وحده. الضفة التي رسمتها اليوم ليست حدوداً تفصل، بل حماية من الطوفان. تمتد من نهر الأردن لتشمل كل من يؤمن أن الكرامة لا تقبل التقسيم. ليس في كلماتها فقط، بل في صمتها أيضاً، في وقوفها حيث لا يقف الآخرون، في رفعها قضايا لا يجرؤ غيرها على رفعها. هكذا تصنع الضفة: لا بالإعلان، بل بالحضور.
والسؤال الذي سيبقى معلقاً: هل سيفهم العالم أن الأردن كله ضفة؟ ضفة استقرار في منطقة انهيار، ضفة إنسانية في زمن الآلة، ضفة صدق في بحر من الزيف. وهل سيفهم أن امرأة من هناك استطاعت أن تجعل من هناك هنا، وأن تحول الضفة من موضع تساؤل إلى فضيلة، ومن أرض محتلة إلى منطلق لإنسانية لا تعترف بالاحتلال؟!
الملكة رانيا تصنع التاريخ لأن الجغرافيا صنعتها. وهذا هو ما يجعل صوتها مختلفاً: لأنه يأتي من جرح قديم، لكنه يخرج كرامة جديدة!
ربما لا يفهمون الآن. لكن بعد زمن من اليوم، حين يقرأ أحدهم كلماتها، سيعرف أن المرأة التي كانت مثار جدل بسبب ضفة هناك، استطاعت أن تحول ذاتها إلى ضفة إنسانية لا تغرق فيها سفينة، بل ترسو فيها كل سفن التائهين. هي لم تعد تنتمي إلى ضفة، بل صارت هي الضفة. ومن لجأ إليها وجد فيها ما ضاع من العالم: كرامة لا تُشترى، وإنسانية لا تتجزأ، ووطناً يتسع للجميع لأنه لا يقوم على أرض، بل على قلب!
هذا هو المعنى الأخير للضفة: أن تكون حداً فاصلاً بين العبث والمعنى، بين الطوفان والاستقرار، بين النسيان والذاكرة. ومن يعيد رسمها لا يحتاج إلى جيش، بل إلى صدق لا يخون، وإلى حضور لا يغيب، وإلى قلب يتسع لضفتين دون أن ينكسر. وهي فعلتها. فهل يفعلها غيرها؟ السؤال مفتوح، والجواب عند يقرأ بعد حين!