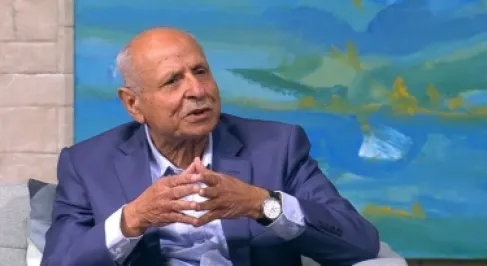خبرني -
ثمة لحظات يتوقف فيها الزمن قليلًا، ليس لأن العالم تغيّر، بل لأن القلب تغيّر. فوز النشامى على المنتخب الإماراتي في كأس العرب لم يكن مجرد انتصار كروي؛ كان لحظة افتتحت شقًا صغيرًا في جدار الأيام الثقيلة، فاندفع منه ضوء أردني خالص يشبه الفرح الذي كدنا ننساه. في بلاد تعوّدت أن تحوّل الصبر إلى حرف، والصمت إلى حكمة، جاءت هذه المباراة كأنها استراحة كونية… كأن الهواء نفسه خفّ فجأة.
ما الذي يجعل العالم يفرح عندما يفرح الأردنيون؟ ربما لأن الفرح الأردني لا يأتي من ترف، بل من شقوق الحياة. لأن الأردني الذي ينهض كل صباح وفي قلبه غزة، وعلى كتفيه الإقليم، وفي جيبه القليل، يعرف أن الانتصار –ولو في مباراة– يشبه استرداد قطعة صغيرة من حقّه في الأمل. وربما لأن صورة الأردن في الوجدان العربي ارتبطت دومًا بالأمان والرجولة والنخوة، ولأن لقب “النشامى” ليس مجرد شعار بل أسلوب حياة: خفةٌ في الروح، صلابةٌ في الموقف، وكرامةٌ تمشي على قدمين.
ومساء تلك المباراة، بدا ذلك الفوز وكأنه يعود إلى جذره الأول. علي علوان ويزن النعيمات سجّلا هدفين يشبهاننا: بسيطان في ظاهرهما، عميقان في أثرهما، من النوع الذي يذكّر الناس بأن الكرة ليست حسابات تكتيكية بقدر ما هي فنّ الحارة الأردنية التي لا تشيخ؛ الحارة التي تتقن لعبة القدم والقلب معًا، وتعرف كيف تُدحرِج الكرة كما تُدحرِج الهمّ، وفي اللحظة نفسها كانت ذاكرةُ الأردنيين تُفتح كما تُفتح نافذة قديمة على ضوء جديد؛ عادت صور الملاعب الترابية، وملامح الطفولة التي تربّت على “اللعبة الحلوة”، والحارات التي كانت تصنع لاعبًا من حجرين وشارعٍ ضيّق وإرادة تُشبه البلاد نفسها: قليلة الإمكانات، عالية الروح، كأن الزمن كلّه تجسّد في صيحة واحدة: نشامى يعشقون الفوز..لكن يعشقون الأرض أكثر!
وفي الخلفية، تكرّر الأغنية القديمة، تلك التي رافقت أجيالًا كاملة:
“بطل الملاعب أردني… يا منتخبنا الوطني”
ترتفع الرايات، وتتماهى الذاكرة مع اللحظة، ويعود التين والرمان ، كمخلوقات رمزية من طفولة جماعية، ليجلسوا في المدرجات يهتفون معنا.
ولم يكن المشهد مكتملًا لولا أن الأمير الحسين نشر تهنئته السريعة والبسيطة: “بداية قوية وموفقة، مبارك للأردن”. جملة قصيرة لكنها تحمل نبض ولي عهد عايش الملاعب كما عايش المسؤولية، يعرف أسماء اللاعبين، ويتابع تفاصيل المنتخب كأنه فرد من الفريق لا وريثٌ للعرش فقط. ومن ورائه ذاكرة كبيرة تعود إلى صورة الملك –سيدنا– أظنها في نهاية التسعينيات، مرتديًا قميص المنتخب، رافعًا يديه بجمال العفوية الأولى، حين كان العالم يكتشف قائدًا جديدًا يبتسم للكرة كما يبتسم للدولة.
ولأن الفرح الأردني دائمًا أعمق مما يبدو، فقد جاء هذا الفوز وسط أكثر مراحل المنطقة تعقيدًا: ظلّ غزة يجثم على الوعي، الحرارة السياسية تتصاعد، الاقتصاد يتقلّب، والناس يقفون على حافة بين التفاؤل والإنهاك، في تلك الحالة "المتشائلة" التي يجيد الأردنيون إدارتها كمن يمشي على حبل رفيع لكنه لا يسقط. لذلك، جاء هدف الأردن كأنه يقول للبلد كله:
ما يزال في القلب مساحة لم تُحتل بعد.
ولعلّ أجمل ما في هذا الفوز أنه أخرج من الأردنيين تلك الطاقة الغامضة التي لا تظهر إلا في اللحظات الفاصلة: ذلك الفرح الذي يبدأ صامتًا ثم يتدحرج مثل كرة ثلج تتغذى من بعضها؛ صوت من شرفة، زغرودة من نافذة، ضحكة طويلة في مقهى، طفل يركض بقميص أحمر، سيارات تمرّ كأنها تعزف… على إيقاع "يا نشامى".
ثم تنفجر الأغنية:
“جيت بوقتك فرفح قلبي… دخيلك شو عمل بقلبي؟”
وإذا بها تتحول من أغنية حب إلى أغنية وطن، من خطاب للعاشق إلى خطاب لمنتخب جعل قلوب الناس كلها تتذكّر أنها قادرة على القفز مرة أخرى.
لقد أعادنا النشامى –ولو لليلة– إلى تلك الفكرة القديمة التي كدنا نفقدها: أن الرياضة ليست استعراض عضلات، بل لحظة تتسع فيها البلاد للقلب، وأن الفوز ليس إثباتًا للآخرين بقدر ما هو وعدٌ للذات بأن القادم يمكن أن يكون أجمل.
ولأن الأردن بلدٌ صغير بمساحته كبير بظله، بلدٌ تعلّم أن يحرس الحلم كما يحرس الحدود، فإن فوزًا كهذا يبدو أكبر من تسعين دقيقة. هو لحظة تقول للعالم:
هنا شعب ما يزال يقاتل بأخلاقه قبل أقدامه، ويبتسم رغم كل شيء، ويهتف لبلده كما لو أنه يهتف لروحه.
أيها النشامى،
يا من صنعتم الفرح من بين أحضان التحدي، يا حراس هذه البسمة الوطنية: دخيلكم، شو عملتوا بقلوبنا؟ أحييتموها بقدمين ترفعان راية، وروح ترفع معنى. وهذا وحده... بطولة تتجاوز الملاعب!