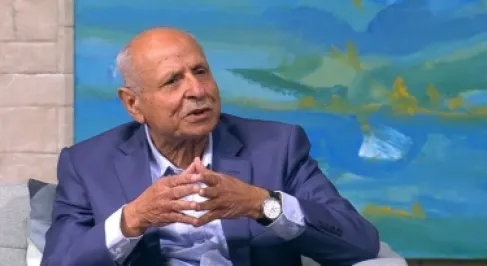خبرني - لم يعد الكمين مجرّد أداة ميدانية تستخدمها أجهزة الأمن في ملاحقة الجريمة، بل غدا ظاهرة تستوجب التمحيص، واختبارًا حقيقيًا لمدى التزام تلك الأجهزة بمبادئ الشرعية والعدالة. فبين الحاجة إلى درء الجريمة وضرورة احترام الحقوق الفردية، تبرز أسئلة ملحّة: هل يجوز أن تتحوّل أدوات الضبط الأمني إلى وسائل لصناعة الجريمة؟ وهل يُعقل أن تتقدّم الحيلة على الحماية في عمل السلطات الأمنية؟ وما الحدود الفاصلة بين الوقاية من الجريمة واستدراج الفرد نحوها؟
هذا الاسئلة تضعنا مباشرة أمام الدور الذي تؤديه الضابطة العدلية، وعلى رأسها رجال الشرطة، فهم – في الأصل – العمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات، حيث أوكل إليهم القانون مهمة الحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات، وكشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها. يتجلى دورهم في التحقيقات الجنائية، وضبط الخارجين عن القانون، إلى جانب حضورهم الفاعل في الميدان العام، ومتابعتهم المستمرة لما يُستجد من وقائع، في مسعى دائم لدرء الجريمة قبل وقوعها. وفي الوقت ذاته، يفترض أن يكون هذا الدور محكومًا بقيود دستورية وقانونية لا يجوز تجاوزها، حتى لا ينقلب السلاح الذي خُصّ به لحماية المجتمع إلى أداة لتهديده.
وإذا كان الأصل في عمل رجل الضابطة العدلية أن يمنع الجريمة، لا أن يسهّل وقوعها، فإن ما تكشفه بعض الوقائع القضائية وما يرصد في واقع اللمارسة العملية يشير إلى وجود تجاوزات تُثير القلق، ليس لأن من ارتكب الجريمة كان ينويها بالضرورة، بل لأن بعضهم لم يكن يحمل في قلبه نية الشر، لكنه دُفع نحو الهاوية بخطوة محسوبة من طرف كان يُفترض به أن يمنع الجريمة لا أن يصنعها. رجل أمن يندس في الظل، يراقب ويترصّد، يختلق الموقف، ويصنع الفرصة، ويضع الطُعم، ثم يُلقي القبض على من وقع فيه، ويُكتب في التقرير أنه "ضُبط متلبسًا". فأي تلبس هذا إذا كانت الجريمة من صنع يد السلطة؟ وأي عدالة يُرتجى من مشهد يتوارى فيه القانون خلف قناع المكيدة؟
إن الكمين في هذه الصورة ليس مجرد عملية أمنية ميدانية، بل هو اختبارٌ أخلاقي وقانوني بامتياز. هو في حقيقته خطٌ رفيع يفصل بين الواجب والانحراف، بين الحماية والتوريط، بين سلطة الضبط التي يخولها القانون، و"مهارة" التضليل التي تصطنع الجريمة لتصنع من المواطن مجرمًا. وإنّ الخطر كل الخطر، أن يتحول رجل الأمن من راعٍ للأمن إلى خالقٍ للخطر، مستبدلًا واجب الوقاية بلعبة الاصطياد. وفي ظل الحاجة المتزايدة لمكافحة الجريمة، قد يظن البعض أن الغاية تبرر الوسيلة، لكن القانون لا يجيز الخداع، ولا يسمح باصطناع الجريمة بحجة كشفها، لأن العدالة لا تُبنى على الحيلة، ولا تُؤسس بالمكيدة.
وفي إطار هذا التوازن بين الأمن والحقوق، تبرز مكانة النيابة العامة بصفتها صاحبة الولاية على الدعوى الجزائية، فهي تمثّل المجتمع وترعى الصالح العام وتتحرّى الحقيقة بحياد وموضوعية. غير أن هذا الدور، على ما فيه من رفعة، لا يكون مشروعًا إلا بقدر ما يُمارَس ضمن حدود ما يسمح به القانون، ويظل مقيّدًا بقيد دستوري صريح، نصت عليه المادة (7/1) من الدستور الأردني بقولها: "الحرية الشخصية مصونة." وتؤكد ذلك المادة (8/1) التي تقضي بأنه: "لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يوقَف أو يُحبس أو أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون."
ومن هنا، فإن أي ممارسة أمنية تستهدف توريط الأفراد في جريمة لم يكونوا ليقترفوها لولا تدخّل الجهة الضابطة، تمثل انتهاكًا مباشرًا لهذا الضمان الدستوري. فليست مهمة أجهزة إنفاذ القانون أن تُغري الأفراد بالانحراف، بل أن تمنعهم عنه وتسدّ أبوابه، وأي انحراف عن هذا المبدأ يفضي إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات العدلية، ويحوّل أدوات الحماية إلى أدوات استفزاز لا أمن.
ويعزز هذا المعنى ما قرّره المشرّع الأردني في نص المادة (8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تؤطر بدقة واجبات موظفي الضابطة العدلية، إذ نصّت على أن: "موظفو الضابطة العدلية مكلّفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والأدلة المادية والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم."
والمفهوم القانوني المستقر أن مهمة الضابطة تبدأ بعد تحقّق الشبهة أو وقوع الجريمة، لا قبل ذلك. أما أن تتحول إلى طرف يُحدث الجريمة ليستدرج المتهم ويضبطه، فذلك انحراف صارخ عن وظيفتها الأصلية وتحولٌ من صفة الحامي إلى صفة الصانع للخطر.
ويعضد هذا الأصل ما استقر عليه الفقه الإسلامي منذ قرون، حين أرسى مبدأ درء الحدود بالشبهات، وهو مبدأ يُقدّم صيانة الحرية على الإسراع في العقوبة. فقد قال النبي ﷺ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة."
بل إن القضاء في الشريعة كان يتردّد في إيقاع العقوبة حتى مع الاعتراف، فيعرض عنه، ويتثبت، ويطلب الشهادة مرارًا، فإن لم تكتمل يُدرأ الحد، وكل ذلك حمايةً لكرامة الإنسان من أن تُستباح بجرأة أو شبهة أو مكيدة.
وفي ذات الاتجاه، رفض الفقه الجنائي الحديث استخدام الاستدراج أو التحريض كوسيلة لضبط الجريمة. فقد أرست محكمة النقض المصرية مبدأ صريحًا قالت فيه : "استدراج المتهم إلى ارتكاب الجريمة من خلال وسائل التحريض غير المشروع، يُفقد الإجراء مشروعيته ويُبطل ما يُبنى عليه من أدلة، ويُعد خرقًا لمبدأ حياد السلطة القائمة على تنفيذ القانون."
وقد تجلّى هذا المبدأ في واقعة شهيرة، حين تعاونت الشرطة المصرية مع أحد المخبرين في افتعال سيناريو لسرقة محل تجاري، بعد اختيار شاب معروف بحسن سيرته، ودفعه إلى ارتكاب الفعل، ليتبيّن لاحقًا أن السيناريو برمّته مفبرك. فقضت المحكمة ببطلان الأدلة وبراءة المتهم، مؤكدة أن الضابطة قد تجاوزت حدود دورها، وتحولت من مانعة للجريمة إلى صانعة لها.
وفي ضوء ذلك، تتعاظم مسؤولية النيابة العامة، لا بوصفها جهة ادّعاء فحسب، بل بصفتها حارسًا على العدالة ومراقبًا لسلوك أجهزة التحقيق. فمتى ثبت أن الكمائن قد استُخدمت للتحريض أو التوريط، وجب إسقاط الأدلة المستخلصة منها، ومساءلة من ساهم في صناعتها، لأن العدالة لا تتحقق حين تُرتكب الانتهاكات باسمها.
وإننا إذ نصل إلى هذه المفاصل الدقيقة في نقاشنا، فلا بد من استحضار البُعد الأخلاقي والوطني في المسألة. فما يوجب تسليط الضوء على هذه الظاهرة ليس مجرد حادثة عابرة أو اجتهاد فردي، بل اتّساع رقعة الأساليب الملتوية باسم الوقاية، وتكرار صور التوريط والاصطناع الأمني، وكأن الغاية تبرّر الوسيلة. من هنا، فإن الحفاظ على صورة الدولة، واحترام القانون، وكرامة المواطن، تقتضي وقفة مراجعة واعية، وتشخيصًا شجاعًا لهذه الانحرافات التي تهدد جوهر العدالة.
وفي ختام هذا المقال، نضع بين يدي الجهات المعنية التوصيات الآتية:
1. سنّ تعليمات واضحة وصريحة تحظر على رجال الضابطة العدلية افتعال الجريمة أو التحريض عليها بأي شكل، وتربط مشروعية الكمين بوجود شبهة سابقة أو بلاغ محدد لا بسيناريو مُفتعل.
2. تعزيز دور النيابة العامة في الرقابة المسبقة واللاحقة على عمل رجال الضبط.3. إسقاط الأدلة المستخلصة من الكمائن غير المشروعة أمام المحاكم، باعتبارها وليدة باطل لا يجوز الاستناد إليها.
4. إعادة تأهيل وتدريب أفراد الأمن على قواعد احترام الدستور والقانون، وتوازن المهام الأمنية مع مبادئ حقوق الإنسان.
5. تبنّي نهج الشفافية والمساءلة في معالجة أي تجاوز يقع من قبل جهات إنفاذ القانون، لأن الثقة لا تُبنى بالتهوين، بل بالتصحيح والمحاسبة.
ختامًا، نعيد التذكير برؤية القيادة الهاشمية الرشيدة، التي عبّر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في أكثر من مناسبة، حين أكّد أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، وأن دولة القانون لا تستقيم بالتجاوز على الحقوق، بل بحُسن تطبيق التشريعات، بعدالة وشفافية، وبما يُعزّز ثقة الناس بمؤسساتهم.
فالأمن الحقيقي – كما عبّر جلالته – لا يتحقق بالقوة المجردة، بل بسيادة القانون، واحترام الإنسان، وصون حقوقه الدستورية. فمن هنا، تُستمد هيبة الدولة، ويُبنى الاستقرار، وتُحمى كرامة المواطن، التي هي أساس الشرعية، لا هامشًا لها.